لم يكن أحد يقبل منذ الصغر بدور العسكري في اللعبة المصرية الشهيرة “عسكر وحرامية”، بينما كان الاختيار يختلف في الواقع، فكان الجميع يتمنى أن يلعب دور العسكري في الحياة، وأن يلتحق بكلية عسكرية ليضمن مستقبلة ويتحصن بامتيازات ضباط الشرطة أو الجيش.
ومن لم يحالفة الحظ في القبول أو لم يتمكن من اكتساب دعم “واسطه” كبيرة تزج باسمة وسط كشوف ضباط المستقبل، كان يخرج من تجربة التقديم وهو يكن في باطنه مشاعر من الغيرة والحقد ناحية كل صاحب “دبورة” يحتك به في يومياته، حتى وإن لم يكشف له ذلك، ويعامله بكل احترام وتقدير في الظاهر، إلا أنه في الحقيقة يكرهه ويتمنى أن يبادله مكانه.
وفي المقابل هناك عدد ليس بالقليل من الضباط الذين تقدموا لكلية الشرطة والكلية الحربية بهدف الحصول على الامتيازات التي يحظى بها الضباط في مصر، وبهدف ممارسة السلطة على عامة الشعب، ولأهداف يراها البعض أتفه من أن تتحكم في خط سير مستقبل شاب واعد يملك الحد المناسب من الإمكانيات التي تؤهله ليكون ضابطا.
وعلي الرغم من ذلك، هناك من يؤيد الضباط ومجهوداتهم ويشيد بها ويحقر من أي وظيفه أخرى يزاولها الغير، حتى وإن كانت مهمة، وفي أغلب الأوقات من عمر الوطن وفي فترات الأزمات الأمنية على وجه الخصوص، يخرج العديد من نشطاء الفيس بوك وتويتر علينا بمنشورات هي الأغرب من نوعها للإشاده بالضباط الذين يحموننا “وإحنا نايمين في بيوتنا”، وكأن الطبيب ترك نبطشيته في المسشفي خوفا من الإرهاب، وكأن محال الطعام أغلقت أبوابها، وكأن الصيدلات أصبحت فارغة من الأدوية والصيادلة!
انظر بحيادية نحو الحقيقة، تجد أن الضابط قرر بمحض إرادته بأن يقدم أوراقه في كلية عسكرية، حتى يقوم بمهام هذه الوظيفه مثله مثل الطبيب الذي قرر أن يكون معالجا، وغيرها من الوظائف التي لا تقل في قيمتها عن غيرها، لذا فلا فرق بين ضابط وطبيب، إلا بالجهد، ولا فرق بين مؤيد ومعارض إلا بالموضوعية، وعلى من اختار أن تكون وظيفته داخل دائرة المخاطر، أن لا ينتظر استحسانا من أحد، ولا إمتنانا على قراره وعلى مجهوده، فهناك من يفني عمره في رسالة من خلال وظيفه لا تقل أهمية عن وظيفه الضابط، الذي إن قدر الله له أن يصاب، لن يعالجه إلا طبيب.
ولم يعد من المقبول أن يعلو أحد على غيره بسبب المسمى الوظيفي، ولم يعد من المقبول أيضا أن يتفه أحد من عمل غيره بسبب أنه لا يحمل فوق أكتافه نجوم ذهبية، فلكل مقام مقال، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
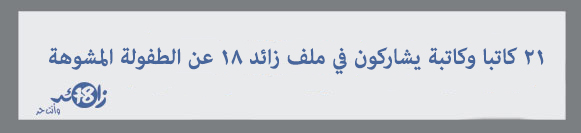





























 sending...
sending...