“ولا باعرف أبكي صحابي غير في الليل”
أنا أيضا مثلك يا خال.. لا أجيد البكاء سوى ليلا.. وحيدا.. عندها أتذكر جميع الراحلين، أتذكر صديق الطفولة الذي كان يسكن بجواري، في نفس الشارع، والذي عاد لنا صبيحة فض اعتصام رابعة العدوية جثة متفحمة.. يقول من حملوا نعشه أن رائحة اللحم المشوي أزكمت أنوف الحاضرين.. لحم البشر المتفحم رائحته سيئة حقًا يا خال عبد الرحمن.
في كل أسبوع، يأتيني صديقي هذا في الحلم.. يقف مبتسما على باب غرفتي نصف المفتوح، يلملم قطع اللحم التي تتساقط تباعا من وجهه، يجمعها في يده، ويمد يده تلك في اتجاهي، وعلى وجهه نفس الابتسامة الرائقة التي كان يطالعني بها ونحن نلعب سويا، منذ سنوات طويلة، على أرضية نفس الشارع.. شارعنا، الذي انهارت عليه أمه صارخة، وهي تودع نعش فلذة كبدها.
والآن أفكر.. وقتها، هل كنتَ في صفوف من أحرقوه حيا يا خال، أم كنت على الضفة الأخرى؟
“وفجأة..
هبطت عـ الميدان
من كل جهات المدن الخرسة
ألوف شُبان
زاحفين يسألوا عن موت الفجر”
يوم جمعة الغضب، وبينما أسيرُ هائما، مندفعا بفعل حماس الجموع، توقفتُ أسفل تمثال “سعد زغلول”، في قلب ميدان محطة الرمل، وأخذتُ أراقب ما يجري حولي، مأخوذا ارتعد، وكأني في رؤيا.. ها هي رؤيتك تتحقق أخيرا يا أبنودي! ها هي ألوف الوجوه الشابة، الذين أرهقهم الفقر وانعدام الأمل في غد أفضل، قد اندفعوا من أطراف المدينة، التي نخر السوس في قلبها، ها هم ينتزعون حقوقهم بدمائهم وأجسادهم التي مزق بعضها الرصاص الحي.. ها هم يتساقطون أمامي بفعل الغاز المسيل للدموع، والبعض الآخر يتساقط بفعل الرصاص مدرجا بدمائه.
أخذتُ أردد هذه الأبيات كالممسوس، وأنا أحاول إفاقة أحد الشباب، بعد أن فقد وعيه بجواري فجأة.. أضغط على صدره، ألطمه؛ ليفيق، وأنا أسأل: يا ترى الأبنودي في صفنا دلوقتي ولا في صفهم؟
“طلع الشباب البديع
قلبوا خريفها ربيع
وحققوا المعجزة
صحوا القتيل مـ القتل”
كم كنتُ سعيدًا عندما سمعتك تلقي هذه الأبيات يا خال! نعم، ها هو الخال عبد الرحمن الأبنودي ينحاز لصفوفنا، لمن خرجوا في ثورة يناير.. ولم لا أفرح وقد تربيت على قصائدك، وقضيت ليال كثيرة أردد قصيدتك الأجمل “الأحزان العادية” – غيبا- بعد أن حفظتها عن ظهر قلب، وتشربتها روحي بصدق.. كنت اعرف أن تاريخك في عهد مبارك به الكثير من السقطات، أوضحها هو “السير بجوار الحائط”.. الصمت أغلب الوقت، وعدم التعليق على مجريات الأمور إلا في أضيق الحدود، وهي السياسة التي اتبعتَها في أغلب سنوات العهد المباركي.
لكننا، في تلك اللحظات، كنا على استعداد لتقبُّل كل من يقف في صفوف حلم يناير.. وكأن الثورة جاءت لتغسل كل من أصاب روحه مسٌ من هوى؛ ليقف بجوار الثائرين.
وعندما أنشدتَ “ضحكة المساجين”، مدحا في سيرة علاء عبد الفتاح؛ لتفضح من سجنوه – العسكر- وهم من فقأوا العيون في “محمد محمود”، وعرّوا الفتيات وكشفوا بالقوة على عذريتهن.. أحسستُ أنه أخيرا قد آن للشاعر أن يحقق قصائده على أرض الواقع.
لكن ماذا يحدث عندما يدوس الشاعر قصائده، يهرس حروفها، ويعجنها بدماء الضحايا، وهو يقف مبتسما بجوار قاتلهم؟
“الوداع يا صوتي ما عدتش أصيل
الوداع يا قلبي ما نتاش قلب نيل
الوداع يا طين بلادي يا مش جميل
الوداع يا نيل أنا مش شاعرك
ولا في إمكاني هز مشاعرك“
هكذا قال الخال في قصيدته الجميلة “اذكروني لما تصطادني الأيادي”، في مقطع شديد العذوبة، رغم قسوته، يثور فيه الأبنودي على الشاعر الذي بداخله، يسخر منه، يهزمه، بعد أن هزمته الأيام.
كلما ظهر الخال خلال وسائل الإعلام، عقب الثالث من يوليو 2013؛ ليُمجِّد في السيسي، ويتجاهل آلاف المظالم التي تُرتَكب يوميا على أرض مصر، كنت أردد هذه الأبيات في سري، وابتلع مرارتي التي تعتمل في حلقي.
لم أستطع أن أكرهه، هذه هي الحقيقة الأوليَّة البسيطة.. حتى وهو يسخر منّا، نحن الشباب، وينعتنا بأننا نقف في صفوف الإرهاب في مواجهة الوطن.
فقط لأننا لم نقبل أن نموت صامتين، دون أن نصرخ.. لأننا صدقنا أن “يا حضرة الظابط أنت كدّاب.. واللي بعتك كدّاب”، ورفضنا أن نصدق الشاعر.. نفس الشاعر، وهو يخبرنا أن الضابط.. نفس الضابط الذي “يهين المعنى.. ويدوس بالجزمة عـ الحلم”.. يمكن أن يكون وطنيا وديعا.
كنت أطالعه حزينا.. لا كارها، وأنا أرى الشاعر يدوس ما كتبه.. يخون قصائده.
لم نكن نحن من خاننا الأبنودي.. لقد خان أغلى ما يملك.. كتاباته.. وعندها، ترى نفسك في مواجهة رجل باع دماغه – حرفيا- لا على سبيل المجاز.
“لما بلغني الخبر
اتزحم الباب
واتخاطفوني الأحباب
ده يغسِّل.. ده يكفِّن.. ده يعجن كف تراب
وأنا كنت موصّي لا تحملني إلا كتوف إخوان
أكلوا على خوان
ومبينهمش خيانة ولا خوّان
وإلا نعشي ما هينفدش من الباب”
عندما قرأتُ خبر وفاته، جلستُ مهموما، ترَّحمتُ عليه، وأخذتُ أتابع المعارك الإليكترونية التي اشتعلت بين من يهاجمه بأقذع الألفاظ، ومن يرفض مجرد المساس به؛ لأن الموت يمنح قداسته لمن يزوره.
كنتُ أرى نفسي، ومازلت، خارج هذه المعركة تماما.. الرجل الآن بين يدي خالقه، وهو وحده أعلم به.. فقط أخذتُ أسأل نفسي: تُرى هل تحققت وصيتك يا خال، وتخاطفتك أيادي الأحباب، الشرفاء، الذين لا يضمون خائنًا في صفوفهم، أم أن رجاءك قد خاب.. ها أنا أرى أحمد موسى وهو ينعيك بأجمل الألفاظ، ويودعك بمزيج من البكاء والصراخ الحاد.. تُرى هل يكون أمثال أحمد موسى من هؤلاء الرفقة الأحباب الذين كتبت عنهم، وتمنيت أن يصحبوك إلى قبرك؟
وأخيرا يا خال..
“وإذا كنت لوحدي دلوقتي
بُكره مع الوقت
هتزور الزنازنة دي أجيال
وأكيد فيه جيل
أوصافه غير نفس الأوصاف
إن شاف يوعى
وإن وِعي ما يخاف”
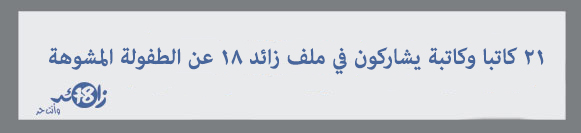
































 sending...
sending...