رفع القاتل مسدسه مصوبا إياه على صدر الضحية، وبثبات أطلق رصاصته، التي اخترقت قلب القتيل، وبينما يتلوى وتنزف دماؤه، ارتفع صوت دقات الدفوف.. وموسيقى زفة العروس!
صرخ المخرج في مساعديه قائلا: “مش دي، فين الموسيقى التانية؟!” ليبدل المساعدون شرائطهم وتنزل موسيقى جنائزية تليق بمشهد الموت.. موقف كوميدي بدأ به فيلم “الجريمة الضاحكة” الذي أنتج في عام 1963، وقام ببطولته “أحمد مظهر”، حيث يؤدي عمله كمخرج في ماسبيرو ويقدم -على الهواء- تمثيليات بوليسية ضمن برنامج “من الجاني”، ولأن أخطاء “الهواء” يستحيل تداركها، فإنها تبقى مجالا ملائما جدا لصنع المواقف الكوميدية.
لكن هذه المرة لم يكن الموقف مشهدا في فيلم كوميدي؛ ففي أحد الصباحات، وبينما أعد القهوة لأبي، وصوت الإذاعة يصدح بارتفاع في أرجاء البيت، كانت المذيعة تتلو الأخبار في عناوين قصيرة تتخللها موسيقى صباحية صاخبة مبهجة.. وخيل إلىّ أنني سمعتها تقول: “وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب”، ثم رنت الموسيقى الفرحة مرة أخرى! خرجت مسرعة إلى أبي لأتأكد مما تناهى إلى أذني، فوجدت على وجهه ملامح الدهشة، وهو يؤكد لي ما سمعته.
كان ذلك في مايو عام 1991، حيث توفي الموسيقار محمد عبد الوهاب، وحكى لي أبي – رحمه الله – بعدها أن نفس الموقف حدث مع دكتور علي مصطفى مشرفة، عالم الفيزياء المصري الأشهر، حين وفاته في 15 يناير عام 1950، حيث بثت الإذاعة الخبر ثم أتبعته بموسيقى وأغاني مبتهجة صاخبة!
الآن، وقد اتسعت أرض الإعلام، ولم يعد الأمر قاصرا على مبنى ماسبيرو – بإذاعته وتليفزيونه – وتعددت القنوات والإذاعات الخاصة، كان المتوقع أن يتبدل الحال ويصير التعامل مع المادة -أي مادة كانت- أكثر رشدا وتقديرا وملاءمة؛ لكن الأحداث تثبت غير ذلك.
ليسوا سواء؛ فالإعلام لا يساوي بين الشخصيات ذات القيمة المتقاربة، وإنما يبدو أن الفيصل في الأمر هو مدى “الحضور” الإعلامي للشخص قبل وفاته، فبقدر ما تكون له صداقات ومعارف وقرابات من العاملين في مجالات الصحافة والثقافة والإعلام، بقدر ما يحظى باحتفاء يليق، ولا أقول أبدا “يتجاوز” لأن كل صاحب قيمة يستحق الاحتفاء ويستحق التذكير به في كل حين، المشكلة في بخس البعض أو تجاهلهم بالكلية، وليست في إكرام الآخرين، لكن هل نحن بالفعل نحتفي بـ”القيمة” أم بـ”الشخص”؟ هذه هي المشكلة!
ما فائدة الاحتفاء من الأصل، سواء بحدث الموت في حينه أو بالذكرى بعد مرور السنوات؟ الحقيقة أن الأصل هو الاحتفاء بـ”القيمة” التي مثلها الشخص في حياته، علمه أو فنه أو فكره، أو بالأحرى إحياء هذا الأثر نفسه، لكي نعيد استذكاره والنهل من معينه واكتشافه، ولتعريف أجيال جديدة، تولد وتكبر في ظل حظ أقل من الثقافة – بحكم حال مترد أو بحكم تداخل ثقافات أخرى أو ظروف سياسية غلبت وشغلت رؤوس الشباب عن اكتساب المعارف أو حتى بحكم أنهم أبناء عصرهم بعلمائه وفنانيه ومفكريه الجدد – لتعريفهم بتلك القيم وبأصحابها، لكن ليس هذا هو ما يحدث في الواقع، فحين يتحمس الإعلام لإحدى الشخصيات ويقرر الاحتفاء بحدث الموت أو بالذكرى، فإن الأمر لا يخرج عن طريقتين، إما حشد جنائزي كئيب، ينفر المتلقي، وإما احتفالية سطحية بكلام مبالغ من المديح والادعاء والاستظراف، بل وبنهش سيرتها أحيانا بما يسيء في ثوب مشفق أو محب، في حين تغيب “القيمة”، عمق ما تركته من أثر؛ إلا في حالات قليلة تعتمد على ثقافة القائمين على العمل بشكل مباشر، كالمذيع والمعدين، وليس على قواعد ثابتة يلتزم بها كل العاملين على الأمر وتُوجههم إلى حيث يليق بالحدث وبالقيمة وببلد عريق.
لدينا علماء ومفكرون وأدباء وفنانون لا ندري عنهم الكثير، بعضهم لا نعرف من حياتهم إلا أمورا شخصية أو حوادث موتهم الماساوية! نحتاج إلى مناقشة فنونهم وعلمهم واكتشافاتهم وأفكارهم التي أنفقوا فيها أعمارهم لتغير حياتنا، فتغافلنا عنها وعنهم وبتنا نعيد أزماتنا وتساؤلاتنا وتيهَنا حول أنفسنا باحثين عن الضوء، ونحن مغمضي الأعين عن شموسنا!
ليس من أجلنا، بالداخل، فقط.. فالاحتفاء اللائق بأصحاب القيمة يعرِّف العالم الخارجي أيضا بنا، كما يفعل الآخرون حين يصدرون لنا منتجهم الفني والعلمي والفكري مستغلين كل مناسبة كبرت أو صغرت، في حين نصر نحن على البقاء في مقاعد الجمهور المتلقي المنبهر، قليل الحيلة!
نحن، العرب، لا نحسن الدعاية لأنفسنا على أي حال، لا فيما يخص قضايانا ولا حضارتنا ولا ثروتنا البشرية بمنتجها، وربما يبدو هذا عائدا منطقيا لما نفعله بأنفسنا أحياء، فنحن لا نجيد في الأصل الاحتفاء بالقيمة حية كانت أو ميتة، وإنما يحكمنا، في كل الأحوال، منطق “الواسطة”! نحتاج إلى إعادة ترتيب أوراق، ووضع قواعد حاكمة لكل مجالات الإعلام وفروعه، نحتاج إلى هجر منطق العشوائية الذي نتبعه بإصرار! نحتاج إلى إدراك قيمة ما نملكه، وإلى الوعي بأن كل قيمة فردية هي إضافة للمجموع، وليست منافسا علينا الإجهاز عليه وخنقه وإطفاؤه أو تجاهله في أفضل الأحوال! علينا – هنا بالذات – أن نحيي فرضية “الحياد الإعلامي” الذي ينحاز للقيمة مجردة بغض النظر عن مواقف شخصية أو مشاعر أو آراء أو وجهات نظر نقدية للقائمين على الإعلام.. علينا أن نعرف كيف نحتفي بأنفسنا، ونعرف لأصحاب القيمة بيننا أقدارهم، وكيف نقدم صورتنا للآخرين، حتى يحتفي العالم بنا ويعرفنا جيدا ولا يسأل من أنتم، كما فعل ماركيز – حسب ما روى البديع إبراهيم أصلان – حين اتصلت به إحدى المجلات العربية لتأخذ منه كلمة تعليقا على وفاة نزار قباني، فسأل بفتور: من يكون مستر كباني؟
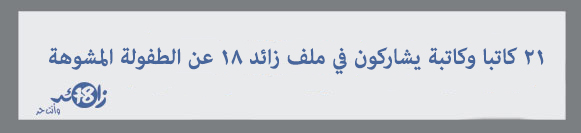


























 sending...
sending...